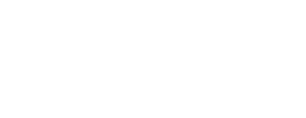

سبحانه لا يحدّه مكان ولا زمان، ولا يمثّله نَصب ولا تمثال فيجب أن تكون عبادته قائمةً على هذا الأساس، وبالطريقة التي يمكن للفكر النسبّي للإنسان أن يناجي بها الحقيقة المطلقة.
وهذا الاتّجاه لا تقرّه الشريعة الإسلامية، فإنّها على الرغم من اهتمامها بالجوانب الفكرية ـ حتّى جاء في الحديث أنّ « تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة »(1) ـ تؤمن بأنّ التفكير الخاشع المتعبّد مهما كان عميقاً لا يملأ نفس الإنسان، ولا يُعبّئ كلّ فراغه، ولا يشدّه إلى الحقيقة المطلقة بكلّ وجوده؛ لأنّ الإنسان ليس فكراً بحتاً.
ومن هذا المنطلق الواقعيّ الموضوعي صُمّمت العبادات في الإسلام على أساس عقليّ وحسّيّ معاً، فالمصلّي في صلاته يمارس بنيّته تعبّداً فكرياً، وينزّه ربّه عن أيّ حدٍّ ومقايسة ومشابهة؛ وذلك حين يفتتح صلاته قائلا: « اللهُ أكبر »، ولكنّه في نفس الوقت يتّخذ من الكعبة الشريفة شعاراً ربّانياً يتوجّه إليه بأحاسِيسه وحركاته؛ لكي يعيش العبادة فكراً وحسّاً، منطقاً وعاطفة، وتجريداً ووجداناً.
والاتّجاه الآخر يفرّط في الجانب الحسّي، ويحوّل الشعار إلى مدلول، والإشارة إلى واقع، فيجعل العبادة لهذا الرمز بدلا عن مدلوله، والاتّجاه إلى الإشارة بدلا عن الواقع الذي تشير إليه، وبهذا ينغمس الإنسان العابد بشكل وآخر في الشرك والوثنية.
وهذا الاتّجاه يقضي على روح العبادة نهائياً، ويعطّلها بوصفها أداةً

(1) بحار الأنوار 6: 133، عن مصباح الشريعة، باختلاف في اللفظ.
لربط الإنسان ومسيرته الحضارية بالمطلق الحقّ، ويسخّرها أداةً لربطه بالمطلقات المزيّفة بالرموز التي تحوّلت بتجريد ذهنيّ كاذب إلى مطلق. وبهذا تصبح العبادة المزيّفة هذه حجاباً بين الإنسان وربّه، بدلا عن أن تكون همزة الوصل بينهما.
وقد شجب الإسلام هذا الاتّجاه؛ لأنّه أدانَ الوثنيةَ بكلّ أشكالها، وحطّم الأصنام وقضى على الآلهة المصطنعة، ورفض أن يُتّخذ من أيّ شيء محدود رمزاً للمطلق الحقّ سبحانه وتجسيداً له. ولكنّه ميّز بعمق بين مفهوم الصنم الذي حطّمه ومفهوم القبلة الذي جاء به، وهو مفهوم لا يعني إلّا أنّ نقطةً مكانيةً معيّنةً اُسبِغ عليها تشريف ربّاني فربطت الصلاة بها إشباعاً للجانب الحسّي من الإنسان العابد، وليست الوثنية في الحقيقة إلّا محاولةً منحرفةً لإشباع هذا الجانب استطاعت الشريعة أن تصحّح انحرافها، وتقدّم الاُسلوبَ السَوِيّ في التوفيق بين عبادة الله بوصفها تعاملا مع المطلق الذي لا حدّ له ولا تمثيل، وبين حاجة الإنسان المؤلّف من حسٍّ وعقل إلى أن يعبد الله بحسّه وعقله معاً.
4 ـ الجانب الاجتماعي في العبادة:
العبادة في الأساس تمثّل علاقة الإنسان بربّه، وتمدّ هذه العلاقة بعناصر البقاء والرسوخ، غير أنّها صِيغَت في الشريعة الإسلامية بطريقة جعلت منها ـ في أكثر الأحيان أيضاً ـ أداةً لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا ما نقصده بالجانب الاجتماعي في العبادة.
ففي العبادات ما يفرض التجمّع بنفسه وإنشاء العلاقات الاجتماعية بين ممارسِي تلك العبادة، كالجهاد فإنّه يتطلّب من المقاتلين الذين يعبدون الله بقتالهم
أن يقيموا فيما بينهم العلاقات التي تنشأ بين وحدات الجيش المقاتل.
وفي العبادات ما لا يفرض التجمّع بنفسه، ولكن مع هذا ربط بشكل وآخر بلون من ألوان التجمّع، تحقيقاً للمزج بين علاقة الإنسان بربّه وعلاقته بأخيه الإنسان في ممارسة واحدة.
فالفرائض من الصلاة شرّعت فيها صلاة الجماعة التي تتحّول فيها العبادة الفردية إلى عبادة جماعية، تتوثّق فيها عرى الجماعة، وتترسّخ صلاتها الروحية من خلال توحّدها في الممارسة العبادية.
وفريضة الحجّ حدّدت لها مواقيت معيّنة من الناحية الزمانية والمكانية، فكلّ ممارِس لهذه الفريضة يتحتّم عليه أن يمارسها ضمن تلك المواقيت، وبهذا تؤدّي الممارسة إلى عملية اجتماعية كبيرة.
وحتّى فريضة الصيام ـ التي هي بطبيعتها عمل فرديّ بحت ـ رُبِطَت بعيد الفطر باعتباره الوجهَ الاجتماعي لهذه الفريضة، الذي يوحّد بين الممارِسِين لها في فرحة الانتصار على شهواتهم ونزعاتهم.
وفريضة الزكاة تنشئ بصورة مواكبة لعلاقة الإنسان بربّه علاقةً له بوليّ الأمر الذي يدفع إليه الزكاة، أو بالفقير، أو المشروع الخيريّ الذي يموّله من الزكاة مباشرةً.
وهكذا نلاحظ أنّ العلاقة الاجتماعية تتواجد غالباً بصورة واُخرى إلى جانب العلاقة العبادية بين الإنسان العابد وربّه في ممارسة عبادية واحدة، وليس ذلك إلّا من أجل التأكيد على أنّ العلاقة العبادية ذات دور اجتماعيّ في حياة الإنسان، ولا تعتبر ناجحةً إلّا حين تكون قوةً فاعلةً في توجيه ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيهاً صالحاً.
ويبلغ الجانب الاجتماعي من العبادة القِمّةَ في ما تطرحه العبادة من شعارات تشكّل على المسرح الاجتماعي رمزاً روحياً لوحدة الاُمّة وشعورها بأصالتها وتميّزها. فالقبلة أو بيت الله الحرام شعار طرحته الشريعة من خلال ما شرّعت من عبادة وصلاة، ولم يأخذ هذا الشعار بعداً دينياً فحسب، بل كان له أيضاً بعده الاجتماعي بوصفه رمزاً لوحدة هذه الاُمّة وأصالتها، ولهذا واجه المسلمون ـ عندما شرّعت لهم قبلتهم الجديدة هذه ـ شَغَباً شديداً من السفهاء على حدّ تعبير القرآن(1)؛ لأنّ هؤلاء السفهاء أدركوا المدلول الاجتماعيّ لهذا التشريع، وأنّه مظهر من مظاهر إعطاء هذه الاُمّة شخصيّتها وجعلها اُمّةً وَسَطاً(2).
هذه ملامح عامّة للعبادات في الشريعة الإسلامية.
وهناك ـ إضافةً إلى ما ذكرنا من الخطوط العامّة التي تمثّل دور العبادات في حياة الإنسان، وإلى ملامحها العامّة التي استعرضناها ـ أدوار وملامح تفصيلية لكلّ عبادة، فإنّ لكلٍّ من العبادات التي جاءت بها الشريعة آثارَ وخصائص ولوناً من العطاء للإنسان العابد، وللمسيرة الحضارية للإنسان على العموم.
ولا يتّسع المجال للإفاضة في الحديث عن ذلك، فنترك الأدوار والملامح التفصيلية، واستعراض الحكم والفوائد التي تكمن في تعليمات الشارع العبادية

(1) قوله تعالى: ﴿سيقولُ السفهاءُ من الناسِ ما وَلاّهم عن قبلَتهمُ التي كانوا عليها قُلْ للهِ المشرِقُ والمغرِبُ يهدي مَن يشاءُ إلى صراط مستقيم * وكذلك جعلناكم اُمّةً وَسَطاً لِتكونوا شهداءَ على الناسِ ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً ﴾. البقرة: 142 ـ 143.
(2) قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلةَ التي كنتَ عليها إلّا لِنَعْلَمَ من يتَّبعُ الرسولَ ممّن ينقلِبُ على عَقِبيهِ... ﴾. البقرة: 143.
في كلّ عبادة من العبادات التي جاءت بها الشريعة إلى مستوىً آخر من الحديث، وقد كلّفنا بعض تلامذتنا بتغطية هذا الفراغ.
ومن الله تعالى نستمد الاعتصام، وإليه نبتهل أن لا يحرمنا من شرف عبادته، ويدرجنا في عباده المرضيّين، ويتجاوز عنّا بلطفه وإحسانه، وهو الذي وسعت رحمته كلّ شيء، ﴿ وما ليَ لا أعبدُ الذي فطرني وإليه تُرجَعُونَ ﴾(1).
وقد وقع الفراغ من هذا في اليوم الثاني من جمادى الاُولى (1396 هـ).
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد
وآله الطاهرين وصحبه الميامين.

(1) يس: 22.
استدراك الطبعة السادسة لكتاب الفتاوى الواضحة
(قد اُوردت هذه التصحيحات في النسخة الموجودة من الكتاب على هذا الموقع)

